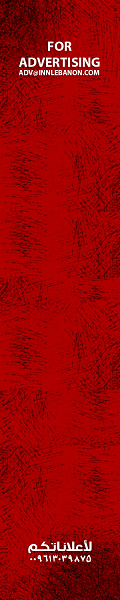"... هذا هو جوابي: ليس لأنني أحببت قيصر أقل، بل لأنني أحببت روما أكثر"
وليام شكسبير | "يوليوس قيصر" | ٣؛٢صيف العام 1994، تكثّف شغف المراهق بكرة القدم. تسمّر وجهٌ على كفّين لشهرٍ كامل يراقب صعوداً إغريقيّاً في دراميّته، مباراة تلو أخرى، لمنتخب البرازيل. لحظاتٌ سوف تسكن ذاكرته إلى الأبد: ثلاثة مدافعين كاميرونيين يلهثون خلف روماريو صفّاً واحداً بينما يتقدّم برشاقة قائد أوركسترا ليودع الكرة في المرمى عبر قدمي الحارس؛ عناق الشكر الطويل بين بيبيتو وروماريو بعد هدف الأول في مرمى الولايات المتحدة بتمريرة من الثاني، وتعابير العرفان الفجائعيّة على وجهه؛ روماريو يقوّس ظهره بضعة بوصات سامحاً لضربة برانكو الحرّة أن تمزّق أحشاء هولندا؛ بيبيتو يهدهد طفلاً خفياً أمام الكاميرا، مهدياً هدفاً ثميناً لمولوده الجديد، مشهدٌ سرعان ما سينضمّ إليه زميلاه في الفريق ليعمّقا تاريخيّته؛ مجهول من الفريق الفني للمنتخب الأصفر يقتحم الملعب بشقلبة أكروباتية بعد لحظة الفوز الصعب بركلات الترجيح على إيطاليا، النهاية الملحمية لكأس عالم لم يكن بالإمكان أن يكون أجمل.ذلك الصيف، وبينما أخرجُ من كأس العالم الحلم مريضاً إلى الأبد بروح البرازيل، مكتشفاً أن الرقص وكرة القدم في تلك البلاد حالتان مشتقّتان من مصدرٍ سحريٍّ واحد، قرّرتُ اغتنام أثر تلك النشوة لتشجيع نفسي على إنفاذ رغبة عاندتني لشهور طويلة: الكتابة.حين جلست أكتب، بقرارٍ مسبق أن يكون النصّ: ١/ بدون تحضيرٍ مسبق، و٢/ عن أمرٍ يثير اهتمامي بشكلٍ أو بآخر، و٣/ يكون جدياً ومتقناً بقدرٍ يجعله صالحاً للنشر، كانت الحصيلة نصّاً عن مشهد انحناءة رأسٍ مصوّرة من الخلف، تنسدل من الرأس جدّولة محبّبة المنظر رغم بشاعتها. وجدتني أكتب نصّاً عن ركلة الجزاء التي أهدرها لاعبٌ مجاهد يدعى روبرتو. روبرتو باجيو. تلك الكرة التي حلّقت فوق العارضة كيَمامة، ولم يرها أي منا تهبط في أي مكان مذذاك. تلك اللحظة الكثيفة بما لا يحتمل، التي يرتجف في مثيلاتها "الزمكان" الإنشتاينيّ إيذاناً بولادة ثقب أسود في مكانٍ ما من هذا الكون. اندلعت فيها مئات ملايين القبل في البرازيل وسائر دول العالم، وانسدرت فيها الدموع في ساحات بلدٍ لم يعنِ لي شيئاً حتى ذلك اليوم، هو إيطاليا. بلدٌ اكتشفتُ لاحقاً أنّه مليء بالساحات، المرصّعة أرضياتها بحجارةٍ كالفسيفساء.
رغم فرح الفوز الدافق الذي يفترض أن تنضح به الروح بحيث لا يبقي متسعاً لنزوات شعورية جانبية، آلمني مشهد روبرتو باجيو مسيحاً. سقط رأسه على صدره كمصلوب فارق الحياة للتو. استعرضت معه، في لحظة مفارقة العالم تلك، الشريط السريع للأحداث التي أوصلته إلى جلجلته، كما يفترض أن يحصل مع كل من يواجه نهاية ملحمية. "إلهي لما شبقتني!". منذ التصفيات الأوروبية المؤهّلة لكأس العالم، انتزع باجيو بذاته مكاناً لبلاده في مونديال أميركا بشق الأنفاس. حمل منتخبه على كتفيه إلى النهائي بسلسلةٍ من الأهداف الحاسمة. في نيجيريا ما زال ثمّة جراح نفسية تضمّد بسببه. وها هو ثقل البشر، أحقاداً ضحلة وقسوةً غريزية وسخريةً سريعة الاستحضار، يتراكم فوق كتفيه، يطقّ عنقه. رغم التعاطف الفطريّ المتوقّع من مشجّعٍ لنادي آي سي ميلان مع المنتخب الذي يحمل شارة قيادته الميلانوي باولو مالديني، كنت أستغرب عجزي عن محبة إيطاليا دولياً. آنذاك كان الاجتماع اللبناني يشهد ثنائية قطبية كبرى تتنازع عصبيات كرة القدم الدولية: البرازيل / ألمانيا، أو الفنّ/العلم؛ هذا دون أن نغفل وجود جيوب صغيرة متفرّقة تشجّع منتخبات أخرى، أبرزها الأرجنتين (مريدو الغورو مارادونا)، وهولندا (قليلو الحظ)، وإنكلترا (الأقل حظاً)، وطبعاً إيطاليا. وكنت قد اعتنقت البرازيل.في جيلنا آنذاك، الفتيات من جمهور إيطاليا كنّ دائماً أكثر من الفتية. كان معظمهنّ، باعتراف معظمهنّ، يشجع وسامة لاعبي الفريق أكثر من الفريق نفسه. وكان هذا واقع طبيعيّ، يعكس تداعيات طبيعية لمعدّلات وسامة غير طبيعية في منتخب إيطاليا، قياساً، مثلاً، بمنتخبات ألمانيا أو بلغاريا أو كوريا الجنوبية. أما انعكاس هذا الواقع في المشجّعين الذكور فقد جاء بأحد شكلين: إمّا حساسية تجاه المنتخب الإيطالي لدواعي الغيرة الذكورية الداروينية في الصميم، أو حماسة مبالغ فيها لصالحه نتيجة رغبة في الاقتراب من مساحة بريق تحوم حولها النساء.يبقى، طبعاً، كمّ من الإناث والذكور ممن، بكل بساطة، يعشقون الأندية الإيطالية (الجوفنتوس، وميلان، وروما، وإنتر… إلخ)، من مهووسي لعبة كرة القدم بدون خلفيات، والذين سيظلمهم هذا التحليل البسودو- فرويدي الأخير. العبرة أننا، جماعة البرازيل، كنا نستسهل كره إيطاليا، أو تسخيف حبّها. وحين يحاول أحدهم أن يعيد تصويب مجرى النقاش من كبوته الصبيانية إلى عقلانيته الرياضية، كنا نهزأ من تغنّي الآدزوريين بمدرستهم "الدفاعية"، من منطلق كونها تقوم على قاعدة الامتناع عن الفعل لا الفعل، وهي سلبيّةٌ تحيل اللعبة إلى شكل من أشكال النكد، تسقط معه مشروعية توصيف "المدرسة". طبعاً، مقاربتنا كانت بدورها سفسطة وليدة النكد.أعيد قراءة كلامٍ كتبته منذ اثنين وعشرين عاماً. أراقب من مسافة جيل، فتى بالكاد يشبهني، يكتب بخطّ يبدو غريباً حقاً، قصّةً يتنازعها الإعجاب والحزن عن لاعب إيطالي يدعى باجيو، كان قرار تكليفه بضربة الجزاء الحاسمة أصوب قرارٍ اتّخذه المدرّب الإيطالي (ما كان اسمه؟ الدفتر يقول: آريغو ساكي) ربما في حياته المهنية كاملةً. "لا أحد في إيطاليا كلها بوسعه تحمّل عبء خسارة النهائي كروبرتو باجيو"، كُتب على الدفتر الأصفر القديم. ولكن ماذا كنت أعرف عن إيطاليا آنذاك؟من الصعب العودة إلى ماضي الذاكرة، إلى مراهقتها. أخال أنّ برج بيزا المائل سيكون أوّل ما سيصادفني حين أضغط زرّ إيطاليا على لوحة مفاتيح ذاكرة ابن الخامسة عشرة. الفاشية أو الفاشستية (تباين في صياغة المفردة بالعربية لم أبادر يوماً إلى محاولة استبيان سببه)، وموسوليني معلّقاً من رجليه في ساحة مجهولة. اللازانيا بولونيز، الخضراء لا البيضاء. بوكاتشيو، والبندقية وتاجرها. رأفت الهجّان يجري اتصالاً مشفّراً بمشغليه المصريين من جنوى. آي سي ميلان. فيردي يلحّن مكبث. فيرونا، وفتاة تدعى جولييت على شرفة. يوليوس قيصر، ومارك آنتوني، و"حتى أنت يا بروتوس". تي إس إليوت يصرّح بأنّ اثنين جاءا إلى هذا العالم وتقاسما الأدب مناصفةً: دانتي الليغييري، ووليام شكسبير. كوريولانوس. سألاحظ أن شكسبير جزء لا يتجزّأ من إيطاليا الذاكرة؛ أو أن إيطاليا الذاكرة المراهقة موسومة بوليام شكسبير. سيحضر من أعماق أبعد في الذاكرة مشهد عناق مع أمي وأبي بعد عودتهما من رحلةٍ إلى روما ولندن، بينما ننتظرهما نحن في جدّة، لدى بيت عمّتي. سأذكر ليلةً واحدة على الأقل صارع ابن الثامنة فيها كآبة موحشة، وبكى كثيراً. لم أكن قد شاهدت فيلم العرّاب بعد في العام 1994. لم تكن موسيقاه التصويرية، وفكّ مارلون براندو الذي ككاسحة ثلوج، وصخب الصقليين الأجوف، أشياء موجودة وتعني لي شيئاً بعد.شكسبير ورمٌ نشأ باكراً وكبر بسرعة. لطالما كانت زيارة أوروبا الحلم الأول، الأكبر. وكنت حين أفكّر بزيارتها تحضر ستراتفورد، ثمّ لندن، ثم الريف الاسكتلندي. باريس لم تدغدغ خيالي ولا مرة، ولا فيينا، ولا مدريد. كوبنهاغن بقيت مصنع زبدة ضخم. برلين بقيت جداراً. روما بقيت متحفاً، مللته من وصف أبويَّ لممرات الفاتيكان المتخمة باللوحات، ولقصصٍ حملاها معهما عن مايكل آنجلو والمنحوتات القابعة في قلب الصخور والتي يكتفي هو بالسماح لها بالخروج. وستشاء المفارقات اللطيفة أنني سوف أنتقل للعيش في أوروبا بحكم الوظيفة بعد سنوات طويلة، في سويسرا تحديداً، وسأزور العديد من دول أوروبا الغربية والشرقية، دون بريطانيا. سأظلّ أؤجّل زيارتها المرة تلو الأخرى، حتى تشاء ظروف العمل مجدداً أن أغادر أوروبا.أذكر مذاق فنجان الكابوتشينو الأول في برغامو، محطتنا الأولى في إيطاليا. أذكر طعمه جيداً، لأنه كان عادياً جداً كأي فنجان كابوتشينو شربته في أي مدينة أخرى، بدءاً من بيروت ووصولاً إلى شارع هوهاي في بكين. قررت ورنا أن نقوم بجولةٍ بالسيارة على مدن شمال إيطاليا، وصولاً إلى البندقية. بعد اختراق الألب، بدأنا ننحدر صوب هضاب لومبارديا التي تعيش في عزلةٍ عن العالم لأنها وجدت قبله، ولأنها، ربما، لم تكن يوماً بحاجة إليه. كل بضعة كيلومترات قلعة رومانية تعتلي تلّةً، تذكّرك بأنّ لهذا المكان تاريخٌ، وبأنّك غريب عنه. نتوقّف للتزوّد بالوقود، فتكون المفاجأة أنّ أحدهم يقف إلى جوار الخرطوم، يقوم بملء الخزان نيابةً عنك، كما في بلداننا، وخلافاً لما هو الحال عليه في سويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وسائر أوروبا الغربية التي أعرف، حيث يملأ كلٌّ وقوده بنفسه. تتراءى لنا من مشهد إيطاليٍّ يحمل مسدس خرطوم الوقود أشياء عن معدّل البطالة في البلد، ومستوى الدخل الفردي، والحدّ الأدنى للأجور. ثم ننزعج إذ ننتبه إلى أنّ العدّة المعرفية التي اكتسبها أحدنا في سنوات ما بعد الخامسة عشرة سرعان ما تستدعي نفسها لتعقّد المسائل، وتنزع عن الأشياء بساطتها. مثلاً، يحضر غرامشي فجأةً، بداعٍ أو من دون داع.بونجورنو/ بونجورنو. غراتزي/ بريغو. لا يتكلمون. يرندحون الكلام، كأنّ ثمة لحناً مستمراً في الخلفية يحاولون ألا يسقطوا عن صهوة نغمته. تهتمّ النساء بجمالهن، ويهتمّ الرجال بوسامتهن. تدقّق النظر فتلاحظ أنهم لا يلاحقون موضة. هم يعيشون كما يرتاحون ويحلو لهم، فيصنعون الموضة في السياق، حتى يفكّر أحدهم أنّ الموضة هي، تعريفاً، الشيء الذي يتأتّى عن مراقبة الإيطاليين عن قرب يعيشون حياتهم اليومية. رغم ذلك، تبدو الفظاظة والوقاحة والصوت العالي، المصحوبة دائماً بلغة جسدٍ وكلامٍ بالأيدي لا فكاك منه، جزءاً أصيلاً لا من المشهد فحسب بل من اللغة نفسها. أبجدية ثلاثية الأبعاد، كأن ثمّة حروفاً ينبغي، كي يصحّ لفظها، أن تترافق مع تلويحٍ بيدٍ أو سقوط حاجب. كأنّ الإيطالية، بهذا المعنى، يتعذّر أن تُقرأ بشمولية بلغة بريل.
البهجة التي لمستها بينما في المقهى المطلّ على الملعب الروماني في فيرونا لم تقتصر على البشر، بل شملت الكلاب أيضاً. إلا أنّها بهجة لحظوية، لا تحاول أن تحجب كمّاً من القرف العام المتراكم البادي على الوجوه المرسومة، والذي، من تجربتنا المحلية في بلداننا، يحيله لاوعينا بدون كثير تعقيد إلى الفساد السياسي المعطوف على اقتصادٍ منكفئ.البهجة. رأيتها أيضاً في روما على وجه تاجر بوظة مريوله ملطّخ بالألوان كرسّام. رأيتها في ميلانو على وجه بائعٍ جوّال يجهد بكل اللغات ليبيعني قميصاً مقرصناً لناديّ المفضّل السابق، الميلان، بسعرٍ بخس. عاجلني بتيشرت الميلان قبل أن يعرف أي فريق أشجّع. قرأ فييّ تقاسيم عصبية الميلان. قلت له أنني مع برشلونة. تابع بهجته بما يوحي بقلة اكتراث، أو بقناعة حاسمة بأنّ الفريقين امتدادٌ لفكرة أو مشروع مشترك. رأيت البهجة على شفاه شابةٍ وشاب، أوفقا سيارتهما في موقف الطوارئ داخل نفق المونبلان، الذي نصفه في فرنسا ونصفه في إيطاليا، فقط ليلتقطا صورة سلفي بينما يتبادلان القبل وقبل أن تصل سيارات الشرطة. لوحة سيارتهما الأوروبية حملت حرف الـI لا حرف الـF. إيطاليان، طبعاً.أعجز عن حصر اللحظة المحدّدة التي، منذها، تسرّبت إيطاليا إلى دمي. لكن أعرف جيداً أنني، في ذلك المساء الجليديّ من أواخر شهر شباط 2013، الذي تكبّدت فيه مشقّة قيادة السيارة من جنيف إلى ميلانو لأربع ساعات، ثم مشيت فيه وصديقي كيلومترين من موقف السيارات وحتى ملعب السان سيرو في بردٍ قطبيّ لمشاهدة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الميلان وبرشلونة، ثمّ تسمّرنا في الصقيع لساعتين لنشاهد الأسطورة ميسّي لا يفعل شيئاً، وليخرج برشلونة مطحوناً بهدفين وثمانين ألف إصبع وسطى مرفوعة في وجهه في اللحظة نفسها – أعرف جيداً أنني خرجت مبتسماً لرؤية أبناء ميلانو العاديين، أطفالاً ومعلمّات حضانة ونجارين وعازفي كمان ومذيعي راديو وعارضات أزياء وحدادين وصحافيين وأطباء بيطريين وسائقي سيارات أجرة وغيرهم، أتى معظمهم من عمله مباشرةً بزيّ العمل، لممارسة شغفه ومساندة فريقه، وتالياً، ودمن ون تعمّد، لمدّ المدينة والبلد وفكرة الرياضة بأسباب الحياة، في لحظة في تاريخ نادي الميلان تغري باستخدامها في جهد معجمي لتعريف كلمة الحضيض. (أقول هذا ويحضرني مشهد المحيطين بي في مدرّجات الكامب نو، ملعب نادي برشلونة، قبل سنة بالتمام. شاب ياباني ينفق أربع دقائق - سجّل خلالها كريستيان تيّو هدفه الأول مع الفريق - لضبط عدسة الكاميرا خاصته، وعائلة سعودية تتقاسم كيسين كبيرين من البوشار، وجمعٌ من الأتراك يرتدون جميعاً قميص برشلونة التي تحمل الرقم 10، كفريق كشّافة). ذلك المساء في ميلانو، خرجت مذعوراً من عصبية الجماهير، مأخوذاً بدفء الإيطاليين. كنت أسمع الشتائم بالإيطالية لفريقي وأعرف أنها شتائم من وقعها على عنقي، لا من موسيقاها. فموسيقى الكلام تعمل، في هذه الحالة فقط ربما، ضدّ المعنى. كل ما لدى هؤلاء دخلت الموسيقى، بشكلٍ أو بآخر، في صنعه. حتى اسم بلادهم. إيـ/تالـ/يا. ثلاثة مقاطع صوتية متعاقبة تضمر نداءات متصلة مجهولة الغاية، كموّال. نجدها مكرّرة هناك، في نشيدهم الوطني. كرة القدم والموسيقى في هذه البلاد، ألاحظ الآن، حالتان مشتقّتان من مصدرٍ سحريٍّ واحد.أطبق دفتر ابن الخامسة عشرة. لا يشغلني مصير ذلك الحلم المبكر، الكتابة، وما حلّ به بعد عشرين سنة ونيّف. لا يحضرني في هذه اللحظة سوى شخص يختزل رابطاً غريباً بين كل المظاهر السحرية التي شغلتني طوال السنوات المنصرمة. كرة القدم، وروح البرازيل، وجدّولة الشعر البشعة، وبرشلونة، والرقص، وشكسبير، والميلان، والموسيقى التي تتعالى كلّما فكّرت – من الآن فصاعداً – بإيطاليا. قيصرٌ يدعى رونالدينيو غاوتشو. أفهم الآن أكثر ماذا فعل بي شكسبير، ولماذا اختُطفتُ نحو البارسا في يومٍ من الأيام، ولماذا مُسِستُ بتعويذة البرازيل، ولماذا لم أشفَ من الحماسة للميلان، ولماذا عاندتُ حبّ إيطاليا، كل هذه السنوات، من دون أي مبرر.
(*) مدونة نشرها الكاتب بشير عزام في صفحته الفايسبوكية