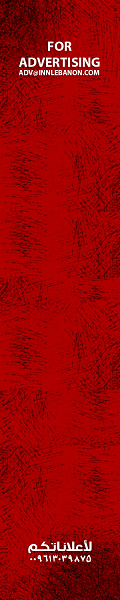في معرض "تجليات عربية: الفن الحديث والتحرر من الاستعمار- باريس 1908-1988"، من السهل جداً على الزائر أن يدخل متسلّحاً بعُدّةٍ نظرية بعينها. غاياتري سبيفاك وإدوارد سعيد... وسائر الأسماء المقترنة بدراسات ما بعد الكولونيالية التي صعدت كـ"تريند" فكري وأكاديمي منذ ثمانينيات القرن العشرين. على باب المعرض، يبدو تأبط ذراع "التابع" (سبيفاك) خصوصاً، فائق السهولة، ومباشراً إلى درجة مثيرة للشك في أن تلك العُدّة هي السبيل الأجدى والأكمل لتلقف تلك الشواهد الفنية وقصصها المتشعبة والمتشابكة مع تاريخ العالم العربي وتحرر شعوبه. ذلك التحرر الذي أفضى إلى استقلالات أتت غالبيتها، عاجلاً أو آجلاً، بأنظمة "وطنية" أقرب إلى منافسة الاستعمار في نهش أبناء جلدتها ولغتها وثقافتها، منها إلى بديل اختاره الناس من بينهم بكامل إرادتهم وقد يستمرون في اختياره لأجل تطورهم وازدهارهم وحريتهم.مدينة كل شيءأسئلة إشكالية كثيرة يبثها المعرض في الرأس، من دون حسم ما إذا كانت تتعلق بفرنسا وحدها، وتحديداً باريس، أم أنها تنسحب على بريطانيا أيضاً، وهما القوتان الاستعماريتان اللتان سيطرتا، بعد السلطنة العثمانية، على معظم بلدان رقعة جغرافية اجترحت لنفسها آنذاك الهوية العربية... هل لباريس خصوصية جمع الشيء ونقيضه؟ أي القوة الاستعمارية، مع القوى الفنية والفكرية المناهضة للاستعمار؟ وانفتاح الكوزموبوليتية، مع المركزية التقليدية ذات الطموحات التوسعية؟...المؤكد أن باريس، لا سيما خلال النصف الأول من القرن العشرين، وبشواهد المعرض "العربي" المقام في متحفها للفن الحديث، لم تكن ولم تصبح شيئاً واحداً، وقطعاً هي أكثر وأغنى من مجرد عاصمة استعمارية."هل يمكن للتابع أن يتكلم؟"، سألت سبيفاك في أطروحتها الشهيرة، فيما وظّفت كل ألمعيتها في دفعنا إلى الإجابة بـ"لا". لكن باريس هنا تطرح إجابة إضافية، معقّدة مثل شغل إبرة "الكروشيه"، في ظلال أعمال مبدعين عرب عرضوا أو درسوا أو عاشوا أو ناضلوا فيها، لفترة وجيزة أو طويلة. منهم من ناهضها في السياسة، على أرضها وبصحبة بعض من أبنائها، من دون أن يتوقف عن النهل من ثقافتها وموارد فنونها. ومنهم من انضوى في مشروعها، لكنه تميّز من قلب ذاك المشروع بصوته الخاص. ليس أجمل من هذا المنطلق المزركش، لانطلاقة زيارة المعرض الذي نقتطف منه هنا ما يرفد الجدل مع عُدّة سبيفاك النظرية، بباريس كمدينة كل شيء.مصالحة فرنسا مع تاريخهايقدم معرض "تجليات عربية" نفسه على أنه "مصالحة فرنسا مع تاريخ الفن أيام الاستعمار وبعده، أي مع تاريخها" (حلم لم يتحقق للمستقلين والوطنيين العرب في بلدانهم). وتبدأ حكاية المعرض من العام 1908، حينما وصل جبران خليل جبران إلى باريس ليلتحق بمدرسة الفنون الجميلة وأكاديمية جوليان. وفي باريس، تعرف جبران على ناشطين سوريين من مشجعي الثورة على الامبراطورية العثمانية، وهي الفكرة ملهمة روايته "الأرواح المتمردة" (1908) التي يقال إنها حرقت في ساحة وسط بيروت.في بدايات القرن العشرين، كانت باريس قد بدأت تُعتبر مدينة كوزموبولتية، ومحطة أشبه بامتياز قد يتمتع به فنان، للدراسة والعرض واحتراف الفن. مثلاً، النحات المصري محمود مختار، والذي يعتبر من رواد الفن العربي والمصري الحديث، صمّم، في باريس، نصب النهضة الشهير في القاهرة، ذلك الذي يمثل امرأة تنزع حجابها وإلى جانبها أبو الهول، تجسيداً لفكرة الانفتاح والحرية التي ألهبته حينها، وأيضاً فكرة صعود الهوية العربية.بدأ إنشاء المتاحف ومعاهد الفن في مصر والجزائر والمغرب وغيرها، تأسيساً على نموذج الفنون العليا الفرنسية. أُعلنت ولادة "فناني السكان الأصليين" (المصطلح القديم للدلالة إلى الفنان المُستعمَر)، ورغم المصطلح الذي أطّرهم بشيء من المهانة، فقد باتوا، للمرة الأولى، مرئيين في أجنحة "المعرض الباريسي الدولي" (1931،1937) الذي أكّد على حدود الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية. إلا أن فنانين مثل فيليب موراني (لبنان)، محمد الراسم (الجزائر) في 1931، أو محمود سعيد (مصر)، استطاعوا تمرير رسالة الشرق كما يرى نفسه، بدلاً من رؤية الغرب له. وكانت تلك بداية ثقافة مناهَضة الاستعمار، التي دعا إليها السورياليون الفرنسيون، مثل فالانتين دو سان بوان وهنري غوستاف جوسو وغيرهما، فانتعشت الدوريات النقدية، والغاليريهات الخاصة، وكذلك فن الكاريكاتور.الفرنسية كاتبة مقدمة "سعد زغلول أبو الشعب"كانت فالانتين دو سان بون قد انتقلت إلى مصر العام 1924، وخلال أحد المؤتمرات هناك، أعلنت "إفلاس الحضارة الغربية" (هل ثبُت ذلك فعلاً؟)، ودأبت أيضاً على نشر المقالات في دورية "لو فينيكس" التي أسستها العام 1925. لم تكتف بشجب الجرائم الكولونيالية البريطانية والفرنسية، بل ذهبت حماستها أبعد، إلى القومية العربية، وهي التي كتبت مقدمة كتاب "سعد زغلول أبو الشعب المصري" لفولاد يكن (1927). أما هنري جوسو، فمنذ العام 1908، ثابر على نشر رسوم كاريكاتورية تفضح جرائم الكولونيالية، في مجلة "لاسييت دو بور" (صحن الزبدة). في العام 1911 استقر في تونس في خضم انتفاضة، واعتنق الإسلام، مبدّلاً اسمه إلى عبد الكريم كبادرة رمزية مُناهِضة للكولونيالية... عندما، كانت للإسلام وأسمائه دلالة رومانسية تحررية، في زمن غير الزمن، ووعي غير الوعي.على قماشة الخلفية هذه، افتُتح المعرض الكولونيالي الدولي، في 6 أيار 1931، في منطقة بارك دو فانسان الفرنسية، والمعرض نفسه كان مناسبة لافتتاح "قصر المستعمرات" (المعروف اليوم بـ"قصر الباب المُذهّب" المخصص للمتحف الوطني لتاريخ الهجرة). في معرض 1931، قُدّم "السكان المحليون" بطريقة مُسيئة، عبر نحو 200 جناح، ويُذكر هنا أن المفوضية السامية للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان، كلّفت فيليب موراني، رسم اللوحات المحيطة بـ"جناح المشرق". هكذا، بدأ عرض "المُهمة الحضارية" الفرنسية للعموم كعمل ثقافي مكمّل للسياسي والإيديولوجي.(واجهة المعرض المضاد للمعرض الكولونيالي الدولي في باريس، 1931)لكنها باريس. وفي باريس، لا سيادة لفكرة، لا فكرة واحدة ترضي الجموع. فأقيم معرض مضاد، في مواجهة "الكولونيالي الدولي"، تم تنظيمه برؤية تهكمية، عبر فن التماثيل الإفريقية التي سلطت الضوء على الاستغلال الكولونيالي. وفي واجهة "معرض الظل" – الذي لم يبق في الظل بتاتاً – تصدّرت عبارة كارل ماركس: "الشعب الذي يقمع شعوباً لا يمكنه أن يكون حراً". كان السورياليون خلف هذا المعرض، إضافة إلى ناشطين من "عصبة مناهضة الاستعمار" والحزب الشيوعي. ورداً على الدعاية الضخمة لمعرض 1931 (حيث بيعت 33 مليون تذكرة لثمانية ملايين زائر)، قام المناهضون بحملتهم الدعائية الخاصة، فوزعوا على المارة حول "قصر المستعمرات"، منشورات وملصقات وكتيبات لم توارب في التنديد بثقافة الاستعمار.ثم، في العام 1937، استضافت باريس المعرض الدولي للفنون والتكنولوجيا في الحياة الحديثة. بُني لهذا الغرض "قصر طوكيو" (الذي يتضمن اليوم متحف الفن المعاصر حيث يقام "تجليات عربية"). وفي هذا المكان المهيب، سعت أجنحة البلدان العربية إلى تقديم أفضل رساميها ونحاتيها الذين تفاوتت "رُتبهم" بين "مصمم ديكور"، و"مُزيّن مساحات"، و"فنان" يعرض أعماله.كانت مصر قد أصبحت مستقلة رسمياً منذ العام 1922، وسعت تيمة الجناح المصري، الذي صممه مهندس العمارة الفرنسي روبير لاردا، إلى تظهير الاستمرارية من الماضي الفرعوني إلى الحاضر الصناعي. وفيه عُرضت تماثيل محمود مختار، ولوحات (بعضها جداريات) لمحمد ناجي ومحمود سعيد ومارغريت نخلة... وهنا تُحكى قصة لقاء مختار (مدرسة باريس 1912) بالزعيم الوطني سعد زغلول، في باريس العام 1919، خلال "مؤتمر السلام" حيث ألقى زغلول خطاب استقلال مصر. كانت تلك الأيام باكورة المرحلة التي ستصبح فيها باريس منصة النخبة المصرية وسرديتها الاستقلالية عن الامبراطورية البريطانية. وبعد أعوام، سينفذ محمود مختار، تمثال سعد زغلول، الذي سيرتفع في إحدى ساحات الاسكندرية العام 1938."العروس" و"الكاهنة" ومحو الأمازيغوفي معرض 1937 أيضاً، رُتّب جناح للجزائر حيث قُدّم فنانون سيصبحون ذائعي الصيت في بلادهم وخارجها، من قبيل أزواو معمري، إضافة إلى أجنحة لمناطق جنوبي المشرق كمستعمرات فرنسية. أما تونس، المحمية الفرنسية منذ العام 1881، فقد عهدت بتزيين جناحها إلى رائد "المدرسة التونسية" علي بن سالم. واتجه أحد مؤسسي "المدرسة التونسية"، عمار فرحات، إلى تجسيد مجتمع تونسي موحد، مستمداً الوحي من الثقافة العربية والإسلامية، مع رموز أمازيغية. ("عروس" عمار فرحات)في لوحة "العروس"، مثلاً، ظهّر فرحات رابط الزواج، إضافة إلى التقاليد الموروثة من الأم لابنتها، ليجعل جسد المرأة أشبه بمعبد لسردية ما قبل الاستعمار، للمحلي، وبالتالي للهوية التونسية الأصيلة. وتحاكي لوحة فرحات أيضاً، تمثال "امرأة القبيلة" للجزائري رباح ملال. القبيلة التي أسطَرها الخيال الكولونيالي الفرنسي، وأبرزت مقاومة شرسة خلال اجتياح الجزائر، فيما مُحيت مساهمتها الأساسية في الاستقلال من السردية الوطنية الجزائرية. وتحاكي "العروس" أيضاً "كاهنة" الفنان جان ميشال ألتان الذي، بأسلوب التجريد المرتبط بـ"مدرسة باريس"، استدعى الملكة الأمازيغية ديهيا، القائدة العسكرية المذهلة التي قادت المقاومة خلال الغزو العربي لشمالي افريقيا، ما جعلها أيقونة الهوية الأمازيغية وكذلك النضال ضد الكولونيالية في الجزائر.منذ الاستقلال.. معركة اللبنانيين مع الفسادمصطفى فروخ، التشكيلي اللبناني الذي لطالما استكشفت لوحاته العريّ، انتقل إلى فرنسا العام 1929 لتعميق مهاراته في "مدرسة الفنون الجميلة". نجح في عرض لوحته "المقهى التركي" في "صالون جمعية الفنانين الفرنسيين" العام 1931، ما منحه بعض الشهرة في باريس. ثم اشتهر بسلسلة من رسوم الكاريكاتور الناقدة للأوضاع في لبنان، خصوصاً بعد استقلال 1943، فتهكم على الطبقة السياسية وفسادها وخيانتها لشعبها أو عدم تمكنها من صيانة الاستقلال عن القوى الأجنبية. رسم الأمة العربية كامرأة يذلّها الانكليز والأميركيون، كما جسّد في سلسلة "المجاعة" التجربة الرهيبة التي مرت على لبنان وسوريا أيام انضوائهما ضمن السلطنة العثمانية.(كاريكاتور مصطفى فروخ)كانت "المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس" بدأت تستقبل الطلاب الاجانب منذ العام 1892، رغم أن النساء لم يتمكنّ من الانضمام إليها حتى العام 1898. من الفنانين العرب الذين نجحوا في اختبار الدخول: المصري محمود مختار، الجزائري محمد إيسياخم، الجزائري من أصل إسباني دونيس مارتينيز، والجزائري شكري مسلي، وكان الأخير أول جزائري ينال الدبلوم العام 1960 رغم فصله بسبب نشاطه مع المقاومة الجزائرية.(رسم اللبناني فيليب موراني، لوحة "إعلان لبنان الكبير" العام 1940، نقلاً عن صورة فوتوغرافية، بعد 20 عاماً على الحدث، إنما بأسلوب فني يحاكي ما يسمى بـ"رسم التاريخ"، بعيداً من أساليب التجريدية والتعبيرية التي كانت طليعية في زمن تنفيذ اللوحة).ومن طلاب صفوف الاستديو، اللبنانيون شفيق عبود وفريد عواد ميشال بصبوص وأمين الباشا، العراقي جميل حمودي، والمصرية مارغريت نخلة. أما أول عراقيَين فازا بمنحة من الدولة العراقية للدراسة في "مدرسة الفنون الجميلة"، فهما فائق حسن (1935) وجواد سليم (1938)، والإثنان باتا من مؤسسي الفن الحديث في بلادهما... بل إن الأسماء أعلاه كلها، أسس أصحابها اللّبنات الأولى للفن الحديث في بلدانهم، ويُعتبرون اليوم أيقونات الفنون الوطنية ومُنطلقات تاريخها المحرّر. (من مجلة "الرغبة الإباحية")والختام بقفزة صغيرة في الزمن، إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وتحديداً إلى العام 1973، عندما تأسست مجموعة "الرغبة التحررية" في الحي اللاتيني بباريس على أيدي فنانين وشعراء ذوي ميول تروتسكية وسوريالية (مروان ديب، فريد لعريبي، علي فنجان، وغيرهم)، تحت قيادة العراقي عبد القادر الجنابي. فنشروا الأعداد الخمسة الأولى من مجلة "الرغبة الإباحية" بالعربية التي وزعت في باريس، وتحت الطاولة في البلدان العربية. كان قد توسّع آنذاك مفهوم التحرر ليشمل الجسد والأفكار والفرد، وكانت باريس ملاذ مبدعين عرب ثاروا على الأديان والتقاليد والرقابات. أما السلسلة الثانية من المجلة عاودت الظهور بين العامين 1980-1981، وفيها نصوص بالعربية والفرنسية، بالروحية الاستفزازية واللاتقليدية نفسها، وبينها أعمال فنية تمثل صور ممثلات أميركيات بلا رؤوس.- "هل يمكن للتابع أن يتكلم؟"- أحياناً نعم، وقد فعل، بل تجلّى، لكنه بعد تحرره، عادت وكبّلته قوى وقيود جديدة، ربما أعنف، وليست بالضرورة امبريالية غربية.